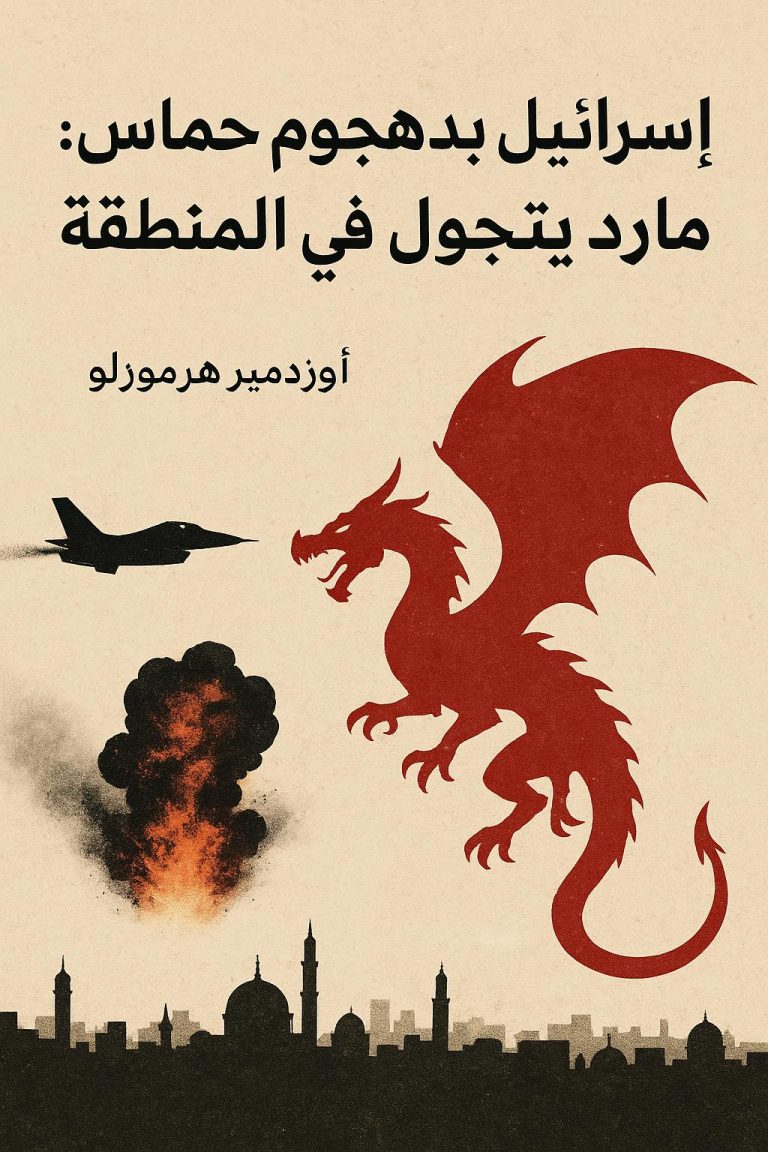الصين والقيادة العالمية
مضر عثمان
خلال العقد الأخير، استطاعت الصين تتويج جهودها التي بدأت قبل 47 عاماً من الإصلاح الاقتصادي لتُظهر للعالم عناصر قوتها بوضوح، فقد حققت قفزات هائلة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتفوقت في أنظمة الاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس، وبرزت قوتها العسكرية في مجالات الصواريخ والفضاء والبحرية، كما رسخت مكانتها الاقتصادية بوصفها “مصنع العالم” وأكبر شريك تجاري لعشرات الدول. كل هذا جعل من غير الممكن إنكار أن الصين ستكون شريكاً رئيسياً في صياغة النظام العالمي الجديد، غير أن قيادة العالم ليست مسألة مال وسلاح وتقنية فقط، بل تحتاج إلى ما هو أعمق من ذلك.
إن التجربة التاريخية تؤكد أن أي قوة عالمية صاعدة تحتاج إلى سردية كبرى قادرة على تشكيل عقول الشعوب وجمعها على مشتركات قيمية وثقافية، وتحويل النفوذ السياسي والعسكري إلى شرعية قيادية مقبولة. الولايات المتحدة لم تكتفِ بالقوة العسكرية والاقتصادية، بل روّجت للعالم سردية الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجحت بمرونة خطابها في مخاطبة العالم المسيحي عبر قيم العدالة، والعالم الإسلامي عبر شعارات تقرير المصير ومقاومة الاستبداد، والعالم العلماني والملحد عبر قيم التحرر الفردي والليبرالية. وهكذا فرضت هيمنتها لا بالقوة الصلبة وحدها، بل عبر الإقناع والشرعية الرمزية.
أما الصين، ورغم صعودها المادي، فإنها تفتقر إلى هذه الشرعية القيمية. فالنموذج الصيني قائم على رؤية قومية مغلقة يديرها الحزب الشيوعي، وليست له جاذبية كونية جامعة. النموذج التنموي الذي تعرضه بكين يرتكز على نجاح اقتصادي وانضباط سياسي، لكنه لا يقدم منظومة اعتقادية أو ثقافية قادرة على أن تكون لغة مشتركة بين شعوب العالم كما فعلت الليبرالية الأمريكية. الثقافة الصينية، سواء في بعدها الكونفوشيوسي أو في قوميتها الحديثة، لا تزال حبيسة حدودها الحضارية، ولم تتحول إلى مشروع عالمي جامع. لذلك ينظر كثيرون إلى الصين كقوة اقتصادية أو عسكرية عظمى، لكن قلّما يرون فيها قائداً حضارياً للعالم. فالقيادة العالمية ليست مجرد تفوق في المؤشرات والأرقام، بل هي قبل ذلك وبعده قدرة على الإلهام وصياغة المشترك الإنساني. ولهذا قد تكون الصين شريكاً إجبارياً في النظام العالمي القادم، لكنها ستظل عاجزة عن لعب دور القائد الأوحد ما لم تُقدّم للعالم مشروعاً ثقافياً وروحياً جامعاً يلتف حوله البشر كما فعلت القوى المهيمنة من قبلها.
لقد خاضت الولايات المتحدة حروباً مدمرة حول العالم وساهمت في إبادة جماعية يندى لها جبين البشرية، ولم يكن أقل من ذلك تأييدها الكياn الأزرق والأنظمة الفسادة في عدة دولٍ في الشرق الأوسط، وكان هذا الموقف مسمار جحى أمام أي جهد لتوحيد شعوب المنطقة وداعماً أكبر للأنظمة القمعية في المنطقة والعالم. ومع ذلك، فإن الصين إذا ما سنحت لها الفرصة، قد ترتكب ما هو أبشع مما ارتكبته أمريكا، بسبب طموحها الاستراتيجي وغياب الشرعية العالمية التي تقيد أفعالها.
إضافة إلى ذلك، تحيط بالصين عدد لا يستهان به من الجيران الذين قد يتحولون إلى أعداء في أي صراع، وحتى إن لم يكونوا بالقوة العسكرية لأمريكا، فإن أي حرب على حدودها لن تكون سهلة، ولن تخرج الصين بعدها كما دخلت، بينما تواجه مشاكل اقتصادية داخلية كأزمة الديون والشيخوخة ومشكلات اجتماعية أخرى كل هذا يعني أن الوقت لا يزال مبكراً لتصور الصين كقوة مهيمنة وحدها، بينما أمريكا ما زالت تملك القدرة على الحفاظ على موقعها كأكبر قوة عالمية، بفضل تقدمها في الفضاء، ومفاتيح السياسة الدولية، وقدراتها الجوية والبحرية، بما في ذلك نظم التأمين البحري وحماية خطوط التجارة العالمية، المشتركة مع بريطانيا وشركاء آخرين. هذه العوامل تمنحها هامشاً للتفوق على منافسيها حتى في ظل تراجع بعض قدراتها النسبية. كما أن الصين غير قادرة على تشكيل حلف عسكري قوي يحقق له نفوذاً حربياً يوزي نفوذها الاقتصادي وغزوها السلعي كما هو الحال بالنسبة لامريكا وقيادتها لحلف الناتو. ونقاط اخرى لا يسع المقام لذكرها في هذه لمقالة المقتضبة.
باختصار، الصين صعدت بسرعة وأثبتت نفسها كقوة صلبة لا يستهان بها، لكنها ما زالت تحتاج إلى سردية كبرى وشرعية قيمية عالمية لتكون قائداً حقيقياً للنظام العالمي، والوقت ما زال مبكراً لتلك النقلة. الا انه على الاقل فإن امريكا ومعها الدول الغربية يجدون اليوم من ينافسهم في مجالات لم يحلمو يوماً ان ينافسهم فيها أحد، فدوام الحال من المحال.
رغم ذلك، مازال الوقت مبكراً.